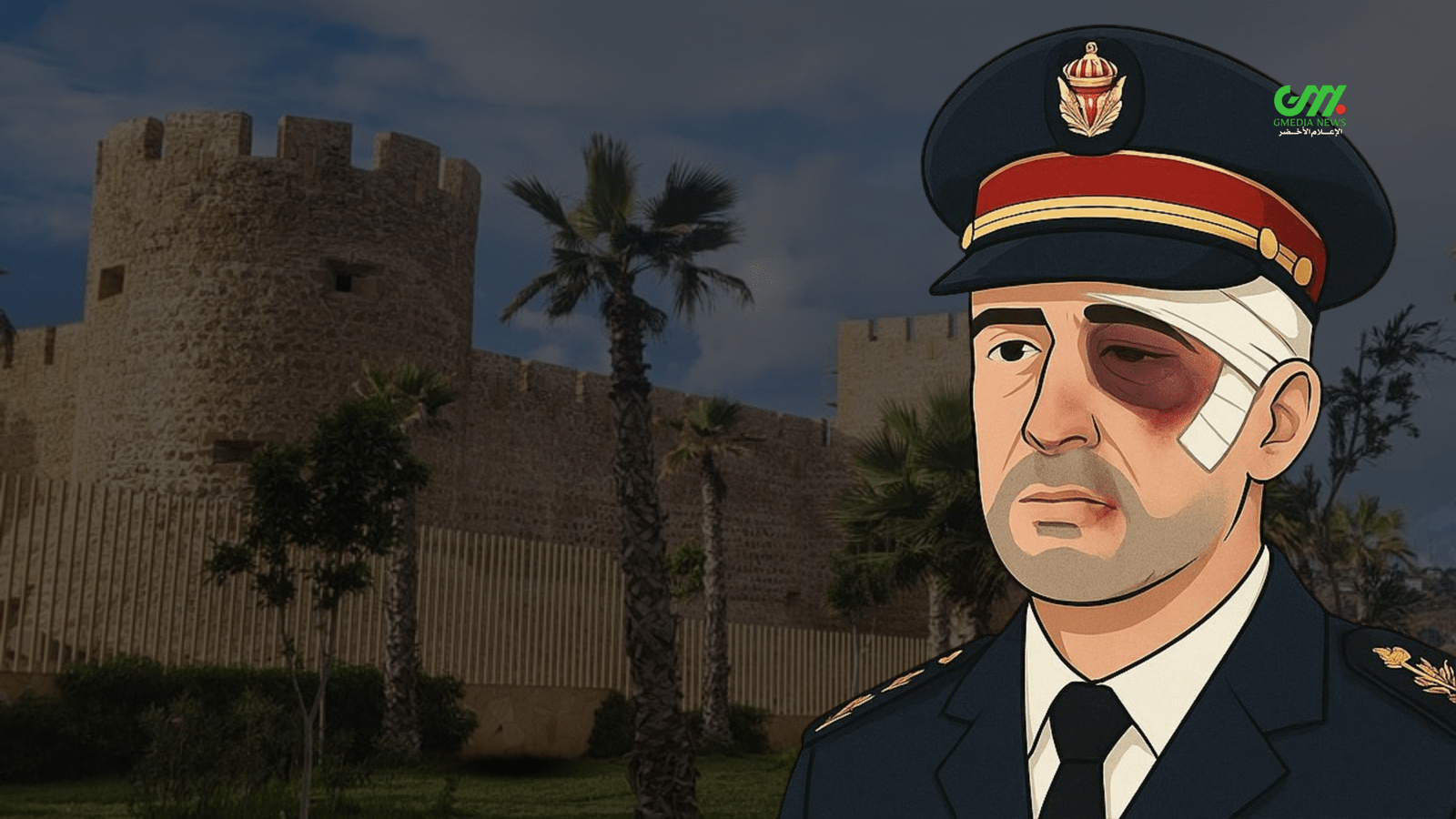بقلم : إيمان بوحزامة
من جديد يعود السؤال الذي نتهرب منه جميعًا: إلى متى سنظل نطبع مع منظومة صهيونية قائمة على الفاشية والاستيطان؟ إلى متى سنمد أيدينا لجهة قامت جذورها على التطهير العرقي، وتستمر يوميًا في ممارسة الإبادة والحصار والتجويع بدم بارد؟ إن المشكلة لم تعد سياسية، بل تحولت إلى امتحان أخلاقي صريح: هل يمكن لبلد بقيمة المغرب وتاريخه أن يستمر في علاقة لا تشبهه، ولا تشبه قيمه، ولا تحفظ كرامته؟
منذ سنة 2021، حين بدأ مسار التقارب، ظهرت أولى الخسائر على مستوى الاقتصاد الوطني. فقد بدأت عدة أسواق إسلامية وعربية ،من الخليج إلى جنوب شرق آسيا ،حملات مقاطعة للبضائع المغربية بسبب ارتباطها بدولة تطبع مع الصهيونية العالمية (Gulf News 2021، Malay Mail 2022). وتقدر قيمة تلك الأسواق بأكثر من مليار دولار سنويًا من الصادرات التي كانت تستقطبها منتجات النسيج والجلد والصناعة التقليدية والمواد الغذائية قبل أن يتراجع الطلب عليها بشكل ملحوظ وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط 2023. وهكذا وجد المنتج المغربي نفسه يدفع ثمن خيار سياسي لم يكن هو طرفًا فيه، ولا يمتلك حتى حق مناقشته.
كما لم يكن قطاع السياحة بمنأى عن هذه الكلفة. فوفق مؤشرات السياحة الخليجية (Travel Market Report 2023)، انخفضت الحجوزات الخليجية نحو المغرب بنحو 23% بين 2022 و2023، وهي نسبة كبيرة بالنظر إلى اعتماد الفنادق الراقية والوجهات السياحية على الزوار القادمين من الخليج. وكشفت وكالات أسفار سعودية وإماراتية عن وجود “تفضيل متزايد لوجهات غير مطبعة”، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نسب الإقبال على مناطق مغربية كانت تعتمد تاريخيًا على الزائر الخليجي. فكيف نقبل بخيار سياسي يفقد اقتصادنا أحد أهم روافده؟
أما الأثر الأخطر، فكان بيئيًا ومائيًا. إذ دخلت شركات صهيونية تعمل في “الري الحديث” و“التجهيزات المائية” إلى المغرب ضمن مشاريع لتحسين تدبير الماء. المشكلة ليست في التقنية، بل في السياسات الموازية التي تعتمد على الاستغلال العميق للموارد المائية، وهي نفس السياسات التي تسببت في تدمير العشرات من الآبار التقليدية في فلسطين منذ التسعينات (مركز المياه الفلسطيني 2019). وقد حذر خبراء مغاربة ،من كلية العلوم بجامعة القاضي عياض بمراكش ،في تقارير سنة 2023 من أن الاستغلال المكثف للفرشات المائية بالأطلس الكبير بين 2018 و2023 غير حساسية الطبقات الجيولوجية، وجعل الأرض أكثر هشاشة في مناطق مثل الحوز. وتظهر معطيات وزارة التجهيز والماء 2022 أن منسوب المياه في جهة مراكش–آسفي انخفض بأكثر من 60 مترًا خلال عقد واحد بفعل الحفر العميق والتدخلات التقنية الثقيلة. ورغم أن الزلزال ظاهرة طبيعية، إلا أن هذا النوع من الاختلال البيئي ساهم في تضاعف حجم الأضرار وفي سرعة انتشار الانهيارات والانشقاقات.
سياسيًا، لم يعزز التطبيع قدرة المغرب التفاوضية، بل تحول إلى مصدر ابتزاز واضح. فقد صرح مسؤولون صهاينة في أكثر من مناسبة بأن الاعتراف بمغربية الصحراء “مشروط باستمرار العلاقات والتعاون العسكري” (Jerusalem Post 2023). وكأن قضية سيادية وطنية قابلة للمساومة أو التهديد. كما دخل المغرب في شبكة تعاون استخباراتي أثارت انتقادات دولية، بعدما أشارت تقارير أممية بين 2021 و2023 إلى استخدام بعض التقنيات الصهيونية في مراقبة المدنيين داخل فلسطين بطرق تنتهك القانون الدولي. فهل أصبحت سيادتنا رهينة اتفاقيات تصاغ خارج أولوياتنا؟
ورغم كل ذلك، تبقى الخسارة الأكبر إنسانية وأخلاقية. فكيف يمكن لبلد يدعم القضايا العادلة منذ عقود أن يقيم علاقة طبيعية مع منظومة قتلت خلال عام واحد فقط أكثر من 40 ألف فلسطيني، وشردت مليونًا ونصف إنسان، ودمرت أكثر من 70% من البنية السكنية في غزة بحسب تقارير UNRWA وOCHA 2024؟ كيف نتعامل مع طرف يستهدف المستشفيات ومراكز الإغاثة والصحفيين ويحول حياة المدنيين إلى جحيم معلن؟ إن التطبيع هنا لم يعد قرارًا سياسيًا فحسب، بل أصبح امتحانًا لضمير شعب لا يقبل الظلم، ولا يبرر القتل، ولا يساوم على الإنسانية.
وربما اليوم، ومع كل ما صار واضحًا بالأرقام والوقائع، صار لزامًا على الدولة أن تعيد النظر في مسار الاتفاق الثلاثي، وأن تقف وقفة مراجعة شجاعة تعيد ترتيب الأولويات وفق مصلحة الوطن، لا وفق ضغوط الخارج. فالعلاقات الدولية ليست قدرًا ثابتًا ولا قيدًا أبديًا، بل خيارات يمكن تعديلها حين يتبين ثقل كلفتها وغياب جدواها. التطبيع لم يجلب للمغرب قوة إضافية ولا حماية سياسية ولا مكسبًا اقتصاديًا، بل جر عليه حساسيات جديدة وخسارات متراكمة ومساحات رمادية لا تليق بتاريخ بلد بنى شرعيته على دعم المظلومين. إن اللحظة الراهنة لا تستدعي الاستمرار في الطريق نفسه، بل تتطلب جرأة في المراجعة، واستعادة البوصلة الأخلاقية والسيادية، ووضع كرامة المغاربة ومصالحهم فوق أي حساب آخر. فالتاريخ يفتح دائمًا بابًا للتصحيح.والسؤال: هل سنملك الشجاعة للدخول منه؟